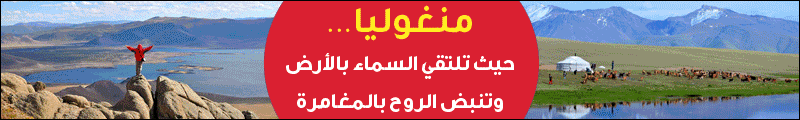تقرير … تنزانيا في إفريقيا نموذج للاستقرار السياسي والتعايش الديني

(الجزيرة)
يتناول هذا التقرير أسباب الاستقرار السياسي والاجتماعي الذي تعيشه تنزانيا، والتساؤل عن أسباب هذا الاستقرار، وكيف نجحت تنزانيا في تكريسه وفي توطيد مبدأ المواطنة والانتماء المشترك في سياق يغلب عليه الصراع الهوياتي فضلا عن إثارة التقرير للتحديات التي تواجه تنزانيا رغم نجاحها السياسي والاجتماعي.
توجد بتنزانيا هويات متعددة شأنها في ذلك شأن أغلب الدول الإفريقية ففيها أكثر من مائة قبيلة وفيها الإسلام والمسيحية وملل محلية غير أنها استطاعت أن تجعل هذا التنوع مصدر ثراء لا احتراب وعامل قوة لا عامل ضعف.
فقد قامت الدولة منذ تأسيسها على اعتماد مبدأ المساواة والتحاور، وكثيرا ما قامت الطوائف بتنزانيا بمناظرات تهدف إلى التقارب والتعايش فتعزز مفهوم المواطنة والانتماء المشترك، وزاد من ذلك اعتماد نظام تعليمي شامل يفتح الفرص أمام الجميع دون استثناء ودون تمييز.
وقد كرس التنزانيون تقليدا في الحكم لم ينص عليه في الدستور لكنه صار سنة متبعة ويقوم على أن يتولى الرئاسة مسيحي ثم مسلم بالتناوب والتوالي وقد اطرد هذا التقليد من أول رئيس مسيحي وهو نيريري إلى الرئيس الحالي المسلم جاكايا كيكويتي وهو الرئيس الرابع.
ومع الوقت صارت تنزانيا نموذجا إفريقيا للتناغم والتلاحم ونقطة جذب للحوار والتصالح، كما نأت بنفسها عن الاستقطابات المحلية والدولية فلم تتورط في المستنقع الصومالي كما فعلت بعض دول الإقليم كما لم تدخل في التحالف الغربي ضد مكافحة الإرهاب وتحديدا التحالف الموجه ضد حركة الشباب المجاهدين في الصومال كما فعل دول إقليمية أيضا.
ومع هذا الانسجام ونجاح تنزانيا في إرسال مبدأ إدارة التنوع وتكريس مفهوم المواطنة فإنها معرضة لتحديات جسيمة قد تؤثر على هذا الوضع منها نزعة الانفصال عند سكان زنجبار وتفاقم الفقر لذلك فإن تنزانيا مطالبة بإجراءات استباقية وحلول وقائية من شأنها أن تحول دون انزلاقات نحو المجهول.
مقدمة
تمتعت تنزانيا -وما زالت- باستقرار شبه كامل مقارنة بنظيراتها في منطقة شرق ووسط إفريقيا؛ حيث لم تشهد حروبًا ونزاعات قَبَلية أو تمردًا مسلحًا أو حروبًا دينية بخلاف معظم دول الجوار في المنطقة، مثل: رواندا وبوروندي والصومال والكونغو وجنوب السودان، والتي خاضت حروبًا قبلية مدمرة أدى بعض منها إلى تطهير عرقي غير مسبوق، وإثيوبيا وأوغندا اللتين ما زالتا تعانيان من حمى التمرد المسلح، وإفريقيا الوسطى التي شهدت مؤخرًا حربًا دينية لا هوادة فيها، فيما ظلَّت الحالة التنزانية عكس ذلك تمامًا، مما جعلها نموذجًا للاستقرار السياسي والتعايش الديني في منقطة تعتبر من أكثر المناطق صراعًا في إفريقيا.
نحاول في هذه الدراسة أن نسلِّط الضوء على هذا الاستقرار السياسي والتعايش الديني، والأسباب المساهِمة في ذلك، وفيما إذا كانت الأسباب تعود إلى طبيعة المجتمع التنزاني أم لا.
نبذة عن تنزانيا
تنزانيا إحدى دول شرق إفريقيا المطلة على المحيط الهندي، تحدها كينيا وأوغندا من الشمال، ورواندا وبوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية من الغرب، وزامبيا ومالاوي وموزمبيق من الجنوب. خضعت تنزانيا لاستعمار بريطاني وألماني كغيرها من الدول الإفريقية واستقلت عام 1961. اشتُقَّ اسم تنزانيا من دمج الاسمين: تنجانيقا وزنجبار اللتين توحَّدتا في عام 1964 لتشكيل جمهورية تنجانيقا وزنجبار الاتحادية والتي تم تغيير اسمها في وقت لاحق إلى جمهورية تنزانيا المتحدة.
وخضعت تنجانيقا لاستعمار ألماني فيما كانت زنجبار مستعمرة بريطانية.
أصبحت زنجبار مستقلة في 19 ديسمبر/كانون الأول1963 ، وتمت صياغة دستورها في المؤتمر الدستوري في “لانكستر هاوس” بلندن بعد مفاوضات بين القوى الاستعمارية والحزبين السياسيين الرئيسيين: الحزب القومي زنجبار (ZNP) الذي كان يمثِّل المجموعات الآسيوية والعرب، والحزب الأفروشيرازي (ASP) الذي كان يمثِّل الزنوج.
اتحدت تنجانيقا وزنجبار لتصبحا جمهورية تنزانيا المتحدة عام 1964، وأصبح أول رئيس لها “جوليوس نيريري” والذي تبنَّى نظامًا اشتراكيًّا أساسه “يوجوما” وهي كلمة سواحلية تعني الاعتماد على النفس والتعاون التقليدي الإفريقي، وقد أثار الاتحاد بينهما جدلًا بين سكان زنجبار، لكنه كان مقبولًا لدى حكومة “نيريري” وحكومة زنجبار الثورية بفضل أهدافهما السياسية المشتركة.
أما عدد سكان تنزانيا فيصل إلى حوالي ثمانٍ وأربعين مليون نسمة ينتمون إلى العناصر الزنجية والحامية، ومن أبرز العناصر: بانتو، الذين يسكنون الوسط، وباشنجا، وماكونزي، ومآلوا، والسوكوما، والسومبوا، ونجيدو، وبوجورو، وزارامو، وشاما وتيتا، وجوجو، وألميرا. وهناك جالية عربية وآسيوية؛ واللغة الرسمية هي الإنجليزية فيما تشكِّل السواحيلية اللغة القومية والوطنية.
يمثِّل المسلمون 60% من السكان فيما يشكِّل المسيحيون 30%، ويتمركز المسلمون في مناطق عديدة فالأغلبية العظمى من سكان جزيرتي بمبا، وزنجبار، وإقليم البحيرة (تنجانيقا) وكذلك سكان مدينة دار السلام (العاصمة)، هم من المسلمين، كما ينتشر المسلمون في ولاية طابورة في الداخل وفي موشي، وكيجوما وأوجيجي.
وصل الإسلام إلى تنزانيا في نهاية القرن الأول الهجري عبر هجرات متتالية من شبه الجزيرة العربية، وتأسست إمارات إسلامية على الساحل الإفريقي إلى الجنوب مثل إمارة “كلوا” الإسلامية، واستقر الأمر للعرب المهاجرين بسبب التجارة أو بسبب الاضطرابات السياسية التي كانت تسود المنطقة العربية في تلك الفترة ومن ثم توغل الإسلام إلى داخل تنجانيقا،
وبرزت مراكز إسلامية بالداخل كان منها في تنجانيقا: طابورة، وأوجيجي على بحيرة تنجانيقا، وتانجا التي كانت من أكبر مراكز الثقافة العربية بالبلاد؛ فيما بزغ فجر المسيحية مع قدوم الاستعمار الأوروبي إلى تنزانيا كغيرها من الدول الإفريقية.
الاستقرار السياسي والتعايش الديني
رغم أن تنزانيا تشارك مع نظيراتها، في منطقة شرق ووسط إفريقيا، كل العوامل المؤدية إلى الصراع العِرقي والديني كتعدد القبائل؛ حيث يوجد فيها قبائل متعدِّدة يتجاوز عددها أكثر من مائة قبيلة، إضافة إلى التنوع العِرقي والديني إلا أنها شكَّلت نموذجًا للاستقرار السياسي والتعايش الديني في منطقة تُعتبر من أكثر المناطق صراعًا في إفريقيا.
لم تشكِّل حدَّة الصراعات العِرقية والسياسية في الواقع الإفريقي والتي ترتبط بمطالب المساواة بين الجماعات العِرقية المختلفة في عملية توزيع الثروة والسلطة جزءًا من الواقع السياسي التنزاني، كما أن التحول الديمقراطي الذي عانت منه دول المنطقة وتتخبط من أجل مضاعفاته وتداعياته حاليًا لم يؤثر عليها بخلاف دول المنطقة كما أسلفنا.
فالمناظرات الدينية بين المسلمين والمسيحيين أصبحت أيضًا شيئًا معهودًا لدى كافة الطوائف الدينية في تنزانيا، بل تعدت ثقافة الحوار الديني إلى أبعد من ذلك لتأثر بعض الدول المجاورة لتنزانيا، وكان لهذه المناظرات صدى على التعايش الديني والاندماج الثقافي في تنزانيا، وقد حافظت تنزانيا على هذا الطابع المتميز والفريد منذ عصور قديمة حتى أيامنا هذه، دون أن تمس بنسيجها المتنوع ومجتمعها المتعدد.
أدى هذا الاستقرار السياسي والتعايش الديني في تنزانيا إلى أن تكون محل اهتمام دولي أدخلها في حلبة الصراع الغربي-الصيني، وكانت زيارة الرئيس الأميركي باراك أوباما وزيارة الرئيس الصيني في فترات متقاربة في بداية عام 2013 تصب في إطار ذلك التنافس.